محمد العزير
بينما يكون هذا العدد من «صدى الوطن» في طريقه إلى المطبعة تكون محكمة الجنايات في مدينة سبوكاين في ولاية واشنطن قد قررت مصير العربي الأميركي المهاجر العراقي الأصل، ياسر دراجي، الذي أدانته هيئة محلفين الشهر الماضي بجناية قتل طليقته ابتهال دراجي وإحراق جثتها، بعد زواج استمر تسع سنوات أنجبا خلالها ولدين، وانتهى إلى طلاق منذ خمس سنوات مشحونة بالمشاكل والتحرشات والتهديدات.
أن يُقدم رجل على قتل زوجته السابقة، أمر شائع إلى حد ملحوظ في كافة المجتمعات، وهو على وحشيته ونذالته وبدائيته، يكون في معظم الحالات عملاً فردياً ينم عن انعدام إنسانية الجاني، خصوصاً في حال وجود أطفال، ويكشف عورات الذكورية الفظة التي لا سند لها سوى تهيؤات «رجالية» بائسة عن الدور الجندري للبشر وأوهام التفوق «الفطري» الموروث من أزمنة غابرة.
المؤسف أن جرائم القتل هذه يتم التساهل معها وأحياناً يتم تأييدها في مجتمعنا العربي الأم الذي نقل بعضنا أحط ما فيه من مثالب، في حقائب السفر التي حملناها معنا إلى العالم الجديد الذي نبحث فيه عن رزق لائق وحياة كريمة ومستقبل أفضل لأولادنا.
تلخص حكاية ابتهال دراجي بوقائعها السافرة أسوأ ميزات مجتمعنا المقيم والمغترب ويتقاطع فيها التخلف الاجتماعي مع التسلط الديني مع الأبوية المعششة في الرؤوس والنفوس، والتي تحول المرأة إلى «هَمّ» و«ضلع قاصر» و«ناقصة عقل ودين»، وفي الوقت نفسه تكلفها الغربة بمهمة خطيرة وهي حراسة «الأخلاق الأصيلة» والذود عن «القيم والعادات والتقاليد» التي يتشدّق بها رجال الدين والذكوريون عموماً، عندما يحاولون درء الحقيقة العصرية الناصعة التي حلت فيها المرأة علماً وتخصصاً وريادة ومسؤولية، ودخولها معتركات كانت –بهمة رجال الدين نفسهم– حكراً على الذكور، بناءً على انتماء منوي وعضو تناسلي لا أكثر.
تزوجت ابتهال في العراق وهي في الخامسة عشرة من العمر (2006). هذا هو العنصر الأول. كيف لبنت في مقتبل مراهقتها أن تصبح ربة بيت، ثم تضع طفلاً وهي في التصنيف القانوني لا تزال طفلة. يقرر الزوج الذي ينتمي إلى عائلة ميسورة نسبياً، الهجرة، فيقتلع ابتهال من عائلتها وبيئتها ومحيطها، ويحط بها الرحال في ولاية واشنطن على الساحل الغربي من الولايات المتحدة حيث استقرت في مدينة سبوكين (2014). هناك يكتشف الزوج «الذكر» الانفتاح الاجتماعي، وبدلاً من أن يركز على تأمين مستقبل ولديه، دخل في علاقة غرامية مع فتاة ثانية ظهرت على الشاشة بعد أن حملت منه. كان على ابتهال «حسب العرف» أن تصمت، فالموروث الديني يقرر أن للرجل الحق في أربع نساء زواجاً وعدد غير محدود من «ملك اليمين».
ارتكبت ابتهال «جريمة» طلب الطلاق (2015) وتم لها ذلك مدنياً، لكن «الشرع» لا يقبل طلاقاً تباشره «أمَة» (بالمناسبة يقول الشرع نفسه إن الطلاق يتحقق متى ما شاء الذكر شفهياً أو خطياً أو عبر رسالة نصية!)، هنا تم تفعيل التحالف الوقح بين الذكورية وبين الدين. ابتهال مطلقة مدنياً ومعلقة دينياً، والزوج، نصف السابق، الوسيم «قاهر قلوب العذارى» الذي لم يتأخر في الاعتداء بالضرب، على صديقته الحامل، حسب وثائق المحاكمة، يعتبر أن ابتهال ملك له. لا يحق لها أن تعيش من دونه (على طريقة أباطرة الصين وسلاطين الهند) لذلك احتفظ لنفسه بحق الزوجية بقوة «رجال الدين»، وككل ذكر شرقي، حاول أن يمسكها من اليد التي تؤلمها… الأطفال، طفليها، فأجبرها على تقاسم الحضانة ليتهرب من مسؤولية النفقة، وهذه كانت أخف ارتكاباته.
عمد المجرم، الذي حرص في جلسات محاكمته على ارتداء بدلاات فاخرة وربطات عنق أنيقة مع تسريحة نجومية لشعره، إلى استخدام المجتمع العربي الأميركي، خصوصاً رواد المسجد والمهاجرين حديثاً، لتشويه سمعة ابتهال. كان يأتي بأصدقائه ليهاتفوا عائلتها وعائلته لتشويه سمعتها وتعييبها عبر المحيطات، فهو الذي اتخذ صاحبة ويرفض أن تخلع ابتهال حجابها، يا له من مؤمن، وهو الذي قرر في أميركا أن يتحول إلى عازب (اجتماعياً) ويتحلل من أية مسؤولية عائلية، فانغمس في الملذات وارتاد المقاهي والملاهي، يستكثر على ابتهال أن تذهب إلى سهرة أو أن يكون لها صديق. هو الذكر… وله القوامة أليس كذلك؟ فانتدب ثلة من الذكور أمثاله، وبعضهم انتقم من ابتهال لأنه لم يتمكن منها، لمراقبتها ونقل أخبارها إليه والشهادة أمام (سماحة) إمام المسجد، وأمام المؤمنين من رواد المسجد الدائمين، وعند الضرورة أمام العائلة في العراق التي تتابع كل خطوة لابتهال ولا تعبأ بتفشيخ طليقها (فعيب الرجل على زناره، أليس كذلك؟).
أخيراً، وجد الطليق فانوسه السحري. اشتغلت ابتهال في مؤسسة خيرية تتخذ من كنيسة محلية مقراً لها. هنا تقدم التسلط الديني على التخلف الاجتماعي. لقد صبأت ابتهال وتنصّرت.. «وا إسلاماه». تحول الإمام والمسجد إلى منسقين دائمين لمتابعة ابتهال إلى درجة أنه عندما زارت العراق لترى أهلها وأصدقاءها عام 2018، احتجزها أهل طليقها (بأي حق؟) واضطرت السفارة الأميركية في بغداد للتدخل بسرية لإعادتها إلى أميركا حيث تجدد الطلب منها أن تتنازل عن طفليها لوالدهما الذي يريد أن يتفرغ لحياة العزوبية بعد انفصاله عن صديقته. طلب المجرم من المتواطئين معه أثناء محاكمته أن يشهدوا بما يراه انحرافاً مسلكياً لضحيته، بينما يراه ما تبقى من مخلوقات خارج البدائية، حرية شخصية.
عندما اكتشف المجرم أن التي تزوجها طفلة صارت امرأة تعرف حقوقها قرر أن يتخلص منها، افتعل معها أول العام 2020، إشكالاً عندما جاءت لاصطحاب ابنها في زيارته الأسبوعية. قرر الجاني أنها غير مؤهلة لأخذ ابنها لأنه يشم رائحة ماريوانا من سيارتها. لم يكن بمقدورها إلا أن تغادر بدموعها دون ولدها، لكن التصعيد الموسيقي الدرامي (الكروشيندو) في سيمفونية الدين والتخلف التي بناها طوال خمس سنوات نضجت في ذهنه، هنا سيكون هو المدافع الأكبر عن الدين الحنيف والقيم والعادات والتقاليد التي لا تتيح لامرأة أن تكون حرة، أو أن تعيش حريتها، أو أن تغير دينها إن شاءت… المسألة في المشيئة، والمشيئة حكر على الذكور في المجتمع والدين.
لاحقها واستوقفها ثم صعد معها في سيارتها –بالمناسبة كانت سيارة صديقة للبيئة– وأقدم على خنقها، بعدها سكب البنزين على جثمانها. قالت صديقته التي انفصل عنها لاحقاً، إنه كان يحتفظ دائماً بغالونات وقود في شقته. أشعل النار فيها على أمل إخفاء معالم جريمته الشنيعة.
بالطبع لا يمكن لعقل بدائي ساذج مثل عقل المجرم أن يستوعب التقنيات الحديثة. لا شك أن المجرم أراد من فعلته أن يثبت لمجتمعه الحديث في واشنطن، وهو المجتمع نفسه في ميشيغن ونيويورك وكاليفورنيا وكل ولاية ذات حضور عربي أميركي، أنه «حامي الحمى». لكنه أمام المحكمة بدا على حقيقته، مخبولاً ومختلاً وممثلاً فاشلاً. عندما سأله الادعاء بكى وانتحب وادعى أنه لا يشارك في جريمة مقرفة كهذه، لكن الأدلة كلها كانت تدينه.
هذه جريمة كلنا شركاء فيها. لم يعد جائزاً ولا مقبولاً السكوت عن النزعات الذكورية وتعميم التخلف وتجميله بادعاءات فارغة عن قدسية العائلة عند العربي والمودة والرحمة والقيم غير الموجودة إلا في كتب من نسج الخيال، ولم يعد يطاق، التماهي مع رجال الدين والتطبيل لهم وجلّهم من أفسد خلق الله أخلاقاً، ومن يريد أن يتأكد من ذلك فليسأل أية «محظوظة» وقعت تحت أيديهم!





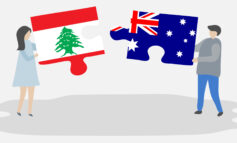

Leave a Reply