محمد العزير
كثيرة هي العناوين التي لا تريد إسرائيل الخوض فيها بعد طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وإذا كان العنوان الأول هو القواعد والمواقع العسكرية السبعة عشرة التي تطوق القطاع وتخنقه منذ 16 سنة والتي استهدفها مقاتلو حماس في هجومهم المباغت الذي شمل الكيبوتزات المنتشرة بينها، وإذا كان العنوان الثاني التغطية على الخسائر في صفوف قوات النخبة من ألوية «جولاني» و«جيفعاتي»، والمظلّيين، من خلال العويل والتباكي على المدنيين والمسنين والأطفال والنساء الذين لم تنشر أسماء أكثر من ثلاثين منهم، فإن عنوان الهجرة المضادة من «أرض الميعاد» غير قابل للنقاش أو التغطية.
فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية منذ منتصف أكتوبر، حظراً على أية أخبار تتعلق بمغادرة الإسرائيليين إلى أوروبا وأميركا بعد بدء الحرب على غزة وتصعيد التوتر في الضفة الغربية وعلى الحدود الشمالية مع لبنان، فبعد «فوضى» التقارير الكثيرة في الأيام الأولى للحرب، والتي تحدثت عن اكتظاظ ردهات مطار بن غوريون بآلاف الإسرائيليين الباحثين عن مقعد في أية طائرة مغادرة، وعن السفن التجارية والبواخر السياحية (التي وفرتها واشنطن لإجلاء الإسرائيليين مزدوجي الجنسية)، وبعد تقارير مباشرة من ليماسول ولارنكا في قبرص وأثينا في اليونان عن تدفق المئات من الإسرائيليين يومياً إلى هذه المدن التي تحولت إلى محطات أولية لهم نحو أوروبا وأميركا الشمالية، اختفى هذا الموضوع عن الشاشة بقرار إسرائيلي وتواطؤ إعلامي غربي سافر.
النزوح بسبب الحرب مسألة إنسانية، والدعاية الإسرائيلية المتفوقة تعرف جيداً كيف تستثمر القصص الإنسانية الفردية وتبني حولها تيارات من الدعم والتضامن، حتى ولو كان الموضوع عسكرياً أسيراً أو جندياً فُقد أثره في معركة، فما بالك بعشرات الآلاف الذين اضطروا إلى ترك بيوتهم وملاعب أولادهم وجيرانهم لينزحوا لأسباب خارجة عن إرادتهم؟ هذه الرواية الإنسانية قد تصلح في الحالات الطبيعية، أما في الحالة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية فلا تجوز لأنها تضرب العمود الفقري لرواية التأسيس، رواية العقيدة الصهيونية التي تعتبر أن اليهودي الجيد هو الذي، بعد لجوئه إلى إسرائيل، يتصرف على أنها «الوطن النهائي الذي لا بديل له»، وقد نعمت هذه الرواية بقبول ومصداقية لا غبار عليهما، منذ نشأة الكيان وحتى «طوفان الأقصى». لم تكن إسرائيل منذ نشأتها قبل 75 سنة، سيدة وحسب، بل كانت مصدر سيادة لمن يشاء أن يجربها! استقطبت بالإرهاب أو الرشوة أو التفاضل يهود المشرق العربي ومصر ومعظم المغرب، ولعبت بصفاقة دور الحامي للأقليات اليهودية من الفالاشا في أثيوبيا إلى اليمن في جزيرة العرب، ووفرت ملاذاً آمناً حتى لليهود الأوروبيين الذين كانوا يساعدون ألمانيا النازية. لكن إسرائيل «الناضجة» لا تريد الحديث عن النزوح منها بسبب «الإرهاب»، لأن لحديث النزوح شجوناً لا وقت لها الآن.
لا يمكن لمن يحاول أن يعرف أعداد الإسرائيليين الذين يغادرون أرض فلسطين مؤخراً أن يعثر على أي مصدر على الإنترنت. هل يمكن تصور الجهد الهائل الذي تبذله الحكومة الإسرائيلية لطمس موضوع يؤرق مواطنيها كهذا؟ كما لا يمكن لأي بحث مهما كان عميقاً أن يخلص إلى نتيجة وافية أو دقيقة، لكن بعض الإشارات غير المقصودة أو التقارير غير المصنفة تعطي نبذة معبّرة عن ذلك. على سبيل المثال يورد تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» تحت عنوان «لاجئون يهود من إسرائيل يجدون المواساة والزمالة في مخيم في المجر». يستعرض المقال كيفية تحول المخيم الذي أنشئ العام الماضي على ضفة بحيرة بلاتوتنوزود لاستقبال النازحين اليهود من أوكرانيا بعد الغزو الروسي، إلى ملاذ لليهود النازحين من إسرائيل، ويشير المقال إلى وجود عشرات العائلات التي لا تعرف إلى أين ستتوجه لاحقاً. وهذا غيض من فيض، إذ استفادت المؤسسات الدينية اليهودية من السخاء الأميركي والأوروبي الغربي وأنشأت ملاذات آمنة في شرق أوروبا للنازحين اليهود من أوكرانيا، لكن مسار الحرب وتعثر الهجوم الروسي جعل معظم تلك المراكز خاوية حتى جاء «طوفان الأقصى» فامتلأت دون كثير من التشهير الإعلامي.
تشير أكثر التقديرات تحفظاً إلى أن ربع مليون إسرائيلي غادروا منذ بدء الحرب، وما يفاقم من القلق الحكومي الإسرائيلي أن هذا العدد يضاف إلى حوالي 750 ألفاً غادروا أو أتمّوا إجراءات المغادرة منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة مع تحالفه اليميني الديني الفاشي، وهذه أرقام مرشحة للزيادة على الرغم من عودة عشرات الآلاف المنضوين في صفوف الاحتياط، وهذا يعني أن عشرة بالمئة على الأقل من الإسرائيليين سيبحثون عن مستقبلهم ومستقبل أولادهم في مكان آخر، وإذا أُخذ بعين الاعتبار، أن البرتغال مثلاً شهدت أكبر ارتفاع في عدد الإسرائيليين الراغبين في استعادة جنسياتهم العام الماضي، من السهل معرفة الحساسية الإسرائيلية الرسمية من هذا السياق، فأكثر من نصف الإسرائيليين لديهم جنسيات أخرى، أو الحق بالمطالبة بجنسيات أخرى.
يقول الكاتب الإسرائيلي روجر ألفر في مقال نشرته صحيفة «هآرتس» تحت عنوان «الإسرائيليون الذين لا يوافقون على مقولة: لا وطن آخر لدينا» أن الرواية الرسمية الإسرائيلية تصرّ على أن ما جرى في السابع من أكتوبر ليس كارثة جماعية… لكنه صرخة للدفاع عن الوطن تحت عنوان «ليس لنا وطن آخر ولو كان وطننا يحترق»، لكن هناك تيار آخر وإن لم يكن رسمياً ولا يتمتع بالإمكانات ذاتها وهو التيار الذي كانت عملية 7 أكتوبر بمثابة القشة التي صسمت ظهر البعير ومزقت إلى الأبد إيمانه بديمومة المشروع المسمى «إسرائيل». ويضيف: لقد حطمت سنوات عشر من «البيبية» (نسبة إلى نتنياهو الملقب بـ«بيبي») مقولة أن إسرائيل يمكن أن توفر لهم ولأطفالهم حياة طبيعية ومستقرة وعاقلة وآمنة. ويتابع أن معظم هؤلاء متعلمون ومثقفون ومهنيون ومبدعون سيتركون هذه الأرض لمن يتصارع عليها من يهود حريديم ومسلمين أصوليين.
هذه المسألة ليست عابرة وليست وليدة ظروف مستجدة يمكن التحكم بها كالعادة، بعد تغير الظروف. قامت إسرائيل على عقيدة أن لا مكان آمناً لليهود إلا فيها. ونجحت إسرائيل لأكثر من سبعة عقود من الزمن في تأكيد هذه العقيدة التي لم يهددها إلا الحضور الأبدي للشعب الفلسطيني بتعبيراته المختلفة والتي سفهت المقولة التأسيسية… «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض». تكمن المعضلة الإسرائيلية الراهنة في زمن ما بعد العولمة في حقائق لا يمكن للماكينة الصهيونية طمسها مهما بلغت براعتها. أبرز تلك الحقائق أن بإمكان اليهودي أن يعيش بأمان وسلام في أي بلد يريد من الولايات المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة مروراً بما بينهما من دول وأقطار، وهذا ما تجلى واضحاً في مداخلات اليهود الأميركيين خصوصاً بعد «طوفان الأقصى». أما الحقيقة الثانية فتتمثل في تحول الجيش الإسرائيلي إلى أداة وظيفية للشباب اليهودي الطامح إلى دخول العالم السيبراني، حيث يخدم خريج الثانوية في القوات المسلحة أربع سنوات غير حافلة بالأحداث والمخاطر، يتخرج بعدها مباشرة إلى شركة معلوماتية إسرائيلية (حيث تصنف إسرائيل ضمن قائمة الدول الخمس الأولى في العالم تقنياً)، أو مباشرة للعمل في شركات كبرى مثل «آي بي أم» و«غوغل» و«فيسبوك» و«ياهو» ناهيك عن عشرات الشركات الأصغر في أميركا، لذلك، كان ملفتاً أن عشرات الآلاف من جنود الإحتياط الإسرائيليين عادوا إلى فلسطين بعد السابع من أكتوبر على متن طائرات «العال» التي سمح لها الكهنوت الديني بالعمل في أيام السبت لأن الأمر جلل.
هذه ليست هجرة عادية ولا موسمية. فمن يتابع وسائل التواصل الاجتماعي يعرف أن جيلاً من اليهود ذوي الجنسيات المزدوجة بدأوا في طرح أسئلة وجودية، من نوع: ماذا تقدم إسرائيل لي مقابل كل الدعم الذي أقدمه لها؟ وماذا يهمني في الصراعات بين اليمين الوسطي وبين اليمين الديني المتطرف وهما لا يتحدثان لغة العصر؟ والأهم: ما هي ضمانات إسرائيل لي وأنا أعيش وأعمل بأمان في أميركا أو فرنسا أو ألمانيا أو كندا أو استراليا وليس في إسرائيل؟ هذا هو السؤال الذي لا تريد الصهيونية الإجابة عليه الآن، لكن عدم الإجابة يعني ما هو أسوأ من أسوأ إجابة.





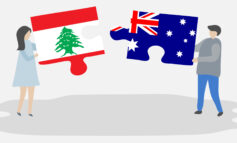

Leave a Reply