حالما تخلص العرب من الحكم العثماني، بدا واضحاً أن القرون الطويلة من الانحطاط والاستبداد لم تنجح في تغييب الشعور بالانتماء إلى العروبة، كحاضن ثقافي وحضاري لشعوب المنطقة. وسرعان ما تبلور هذا الوعي مع تواتر الاستقلالات الوطنية ونشوء الدول العربية التي عبرت شعوبها بحماس منقطع النظير عن إيمانها بالوحدة من خلال التفافها حول شعارات الزعيم جمال عبد الناصر العروبية الوحدوية، التي نجحت –بشكل جزئي ومؤقت– في إنجاز الوحدة بين سوريا ومصر في ١٩٥٨، رغم مناهضة كل القوى الرجعية العربية والمحلية المرتبطة بالقوى الاستعمارية العالمية.
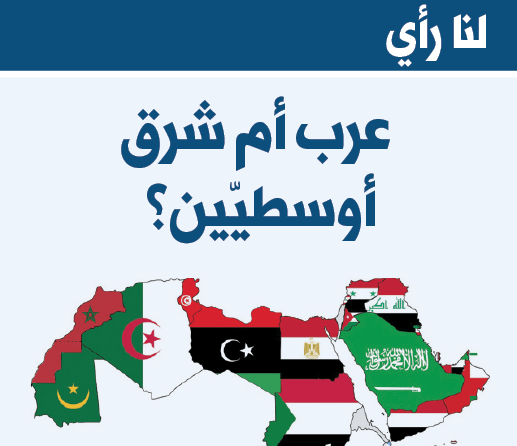
ورغم أن العقود الأخيرة قد شهدت تراجعاً نافراً للطروحات الوحدوية والانتماء العروبي على المستوى السياسي، إلا أن الشعوب العربية، بمختلف فئاتها –من المحيط إلى الخليج– ما تزال تتمسك بهويتها العربية، رغم كل ما عصف بها من مصائب ومحن وهزائم سياسية وعسكرية ونفسية، إضافة إلى الانقسامات الفئوية والمذهبية، التي تتوخى أهدافاً بعيدة عن مصالح شعوب المنطقة وتتلاعب بمصيرها.
ورغم كل ما أصاب صورة العروبة أمام العالم من تشويه وانحطاط، لا يزال العرب مرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بجذورهم الحضارية، بمن فيهم العرب الأميركيون الذين يصرون على بلورة كينونة خاصة في وطنهم الجديد تميزهم كمجتمعات عربية متمايزة في النسيج الأميركي المتنوع، لها مرجعياتها الاجتماعية والثقافية والحضارية الخاصة والمختلفة عن الثقافة الأميركية السائدة التي نجحت في تذويب العديد من الهويات العرقية والدينية وصهر الأقوام والجماعات في بوتقة واحدة، غير أن ثراء وعمق الإرث الحضاري للعرب الأميركيين ساهم في تميزهم بحفاظهم على تقاليد وأعراف مكنت مجتمعاتهم من الازدهار والترسخ، لاسيما في منطقة ديترويت الكبرى التي تزخر بفسيفساء عربية متنوعة من مختلف الطوائف والانتماءات.
غير أن ازدهار وتوسّع المجتمعات العربية في الولايات المتحدة، واعتزاز العرب الأميركيين بهويتهم، لم يقابل باعتراف رسمي، حتى أن جهود المؤسسات العربية لإقناع الحكومة الفدرالية بإدراج خانة خاصة بالعرب في الإحصاء الوطني لعام ٢٠٢٠ بدلاً عن تصنيفهم كـ«بيض»، قوبلت بمقترح رسمي يقضي باعتبارهم منحدرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جنباً إلى جنب مع تركيا وإيران وإسرائيل.
حتى أن حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر أقدم على تغيير اسم «الهيئة الاستشارية لشؤون العرب والكلدان الأميركيين» إلى «الهيئة الاستشارية للشؤون الشرق أوسطية»، علماً بأن الحاكم الجمهوري الأسبق جون أنغلر كان قد أسس هذه الهيئة في أوائل التسعينات باسم العرب، قبل أن تضيف إليها الحاكمة الديمقراطية السابقة جنيفر غرانهولم الكلدان في العام ٢٠٠٤.
والمؤسف أن تسمية شرق أوسطيين، لم تعد تقتصر على وسائل الإعلام والبيانات الرسمية المحلية والفدرالية، بل أصبح الكثيرون من العرب أنفسهم، أفراداً ومؤسسات، يفضلون هذه التسمية، التي أطلقها الاستعمار البريطاني على المنطقة، بعد الحرب العالمية الأولى حيث قام بتقسيم «الشرق» بحسب البعد الجغرافي عن لندن.
إن مسألة بلورة الهوية العربية في الولايات المتحدة، بدأت مع موجة الهجرات الأولى من سوريا الكبرى في نهاية القرن التاسع عشر، عندما كانت البلاد العربية واقعة تحت الحكم العثماني. وأيامها لم تقتصر طموحات المهاجرين العرب الأوائل، ومعظمهم من المسيحيين، على التحرر من استبداد الباب العالي في اسطنبول، والتمتع بحرية التعبير عن الذات، أفراداً وجماعات، في الولايات المتحدة التي قامت بتصنيفهم رسمياً ضمن خانة «المغوليين»، بما يعني أنهم ينحدرون من سلالة العرق الأصفر.
وحدثت نقطة التحول على خلفية اعتقال شرطي عربي لأميركي أبيض، حين ادعى والد المعتقل على الشرطي لدى المحكمة ببطلان الاعتقال بدعوى أنه «من غير الجائز قانونياً لمغولي أن يعتقل شخصاً أبيض»، فما كان من الشرطي جوج شيشم إلا الدفاع عن نفسه عبر سَوق حجج دينية، قائلًا: «إذا كنتم تعتبرونني مغولياً، فهذا يعني أن المسيح هو مغولي أيضاً، فأنا والمسيح جئنا من نفس البلاد».
وعلى التوازي، أطلقت الجاليات العربية في ذلك الحين حملة لنفي نسبها إلى العرق الأصفر واستبداله بالعرق الأبيض. وفعلًا قام ناشطون ومحامون منهم بمراسلة الجامعات الأميركية ومراكز البحوث المختصة للاستعانة بشهاداتهم ودراساتهم البحثية الأكاديمية لدى المحكمة. وانتهت القضية بحصول الشرطي شيشم على الجنسية الأميركية، كشخص أبيض. وقد استمرت الحملة الحقوقية لعدة سنوات تالية، حتى تم اعتماد العرب رسمياً كمواطنين ومقيمين بيض، في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين.
ومنذ ذلك الوقت، واصل العرب جهودهم لبلورة هويتهم الخاصة في أميركا، وهو الأمر الذي تؤكده التسميات الكثيرة التي اعتمدتها المنظمات والجمعيات والمراكز والنوادي الناشطة في مختلف الحقول والمجالات في الولايات المتحدة، حيث يحرص أصحابها على تسميتها بـ«مؤسسات عربية أميركية» ترسيخاً لوعيهم بهويتهم وانتمائهم العربي، وصولاً إلى متاجر البقالة والمطاعم التي تحمل لافتات وأسماء عربية.
لكننا بدأنا نلاحظ في الآونة الأخيرة عزوف بعض المؤسسات عن اعتماد أسماء عربية واستبدالها بـ«التسمية الشرق أوسطية» بدون إبداء أية مبررات.
قد يكون السبب وراء ذلك السلوك هو رغبة أصحابها في دفع الشبهة عن أنفسهم كعرب، أو لعلها مجرد مناورات لضمان حصول مؤسساتهم غير الربحية على بعض المساعدات من المؤسسات الحكومية والفدرالية، علماً بأن مصطلح «الشرق الأوسط» معتمد في الدوائر السياسية والأكاديمية والإعلامية، حول العالم، بما فيها الدوائر الأميركية التي تستخدم هذه التسمية للإشارة إلى العالم العربي، منذ أوائل القرن الماضي.
ولكن ما يعنينا في هذا الموضوع، هو أن اعتماد المؤسسات العربية الأميركية «التسمية الشرق الأوسطية» قد لا يكون في مصلحة العرب الأميركيين، إذ قد يشكل هذا التصنيف ذريعة لاستبعادهم عن الدوائر الحكومية والرسمية (التي عليها أن تعكس تنوع المجتمعات) بذريعة وجود تمثيل كاف للشرق أوسطيين!







Leave a Reply